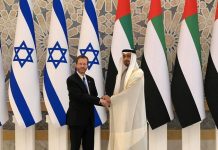Apr 11, 2017m – http://www.alquds.co.uk
Apr 11, 2017m – http://www.alquds.co.uk
توفيق رباحي
بين حوادث الدهس الإرهابية في مدن نيس وبرلين ولندن وستوكهولم، مرت أقل من سنة، لكن قرونا من الكراهية والمشاعر السلبية تراكمت، ومعها كمّ لا يقاس من الحزن والمآسي.
الجناة، إرهابيون قتلة غُسلت أدمغتهم بإغراءات من قصص الخيال المجرم، وبالحجج الواهية التي يحق للمرء أن يتساءل كيف تنطلي على بشر.
الضحايا أهداف سهلة ومستباحة.. مدنيون، أطفال ونساء، عُزّل أبرياء لا ذنب لهم سوى وجودهم في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ.
 ليس كل المسلمين إرهابيين، لكن كل الإرهابيين في هذه الجرائم مسلمون. وكلهم ارتكبوا جرائمهم النتنة تحت يافطة واحدة لا تخرج عن أوهام نشر الإسلام أو الدفاع عنه.
ليس كل المسلمين إرهابيين، لكن كل الإرهابيين في هذه الجرائم مسلمون. وكلهم ارتكبوا جرائمهم النتنة تحت يافطة واحدة لا تخرج عن أوهام نشر الإسلام أو الدفاع عنه.
وهذا كاف لإتمام عناصر اللوحة القاتمة لأتباع هذه الديانة في المجتمعات الغربية «الكافرة» التي ذهبوا إليها بعد أن ضاقت بهم مجتمعاتهم «المؤمنة» الطاهرة!
وقفتُ طويلا أبحث عن سبب واحد قد يبرر جريمة ستوكهولم مساء الجمعة، فتعبت ولم أجد. فكرت في معضلة فلسطين وضياع العراق وجوع الصومال ومعاناة الروهنغيا في ميانمار والإسلام الغريب في كل مكان، وفي غيرها، فلم أجد. لم يتقبل ذهني المنهك أن يأتي وحش ويدوس الناس المسالمين بشاحنته المجنونة هكذا كأنه يدوس ذبابا.
وصلت إلى قناعة أنه بعد هذا ليس من حق أحد أن يلوم المجتمعات الغربية إذا ما اتخذت مواقف سلبية أو حتى عدائية من المسلمين. بل لا غرابة ولا لوم على زحف اليمين المتطرف وتنامي مشاعر وجرائم الكراهية.
وانتابتني مخاوف، في المقابل، من أنه سيكون من الصعب جداً بعد اليوم أن تكون فتاةً محجبة في مترو أنفاق لندن أو قطارات ستوكهولم، أو باصات برلين وروما. ستتعب في عيشك مسلما في مدينة أوروبية، مهما كانت براءتك من هذه الجرائم وإيمانك بهذه المدينة وانتماؤك لها، لأن الخسائر فادحة وبلغت حداً يصعب تداركه أو إصلاحه.
سيكون من الصعب، وربما من المستحيل، أن تنجح في الدفاع عن دينك وثقافتك ولغتك في مجتمعات، هناك من بني دينك وثقافتك من يعمل على إبادتها وحرقها.
لو وقف سفاح ستوكهولم في الشارع ذاته في المساء ذاته، واستجدى الناس يعطونه رغيفا، كان سينهي يومه بمائة رغيف وألبسة وأغطية ومصروف يشتري به سجائر، من ذات الناس الذين قتلهم وجرحهم وأدخل الحزن إلى عائلاتهم.
إذا كان هدف الجاني ضرب «الكفر» و»الكفار»، و»العنصرية» والعنصريين»، فهو حتما ضلّ الطريق وأخطأ الهدف. هؤلاء الذين يسقطون بفعل الشاحنات ليسوا كذلك. «الكفر» نحن، و»الكفار» نحن. و»العنصرية» نحن، و»العنصريون» نحن.
نحن الذين نشأنا على رفض الآخر و»الكفر» به ونوغل في ذلك. نحن الذين ترعرعنا في مجتمعات منحرفة علمتنا أننا الأفضل والأنقى والأعلى، وغيرنا الأنجس والأصغر لأنه يختلف عنا عرقا أو دينا، أو الاثنين معا. نحن الذين أقفلنا أبواب بلدان حقيرة وفاشلة في وجوه اليائسين والمستجيرين والهاربين من جحيم حروب سببها جهلنا وظلام عقولنا وتحجر فكرنا. نحن الذين نحلم برؤية المساجد وسماع نداءات الصلوات الخمس في عرين الغرب، ونرفض للآخر مجرد التفكير في بناء كنيسة صغيرة في بلداننا.
غير القيَم الإنسانية والشعور بآلام الآخر، لا شيء يجبر ألمانيا أو السويد أو كندا على استقبال آلاف وربما ملايين اللاجئين الذين من شأن تكاثرهم ان يخلَّ بالتركيبة الديمغرافية للمجتمع. ورغم تلك المخاوف، فقد فعلت بصدر رحب وقلب كبير. آوت الناس وأطعمتهم، بينما أغلقت الدول العربية، حاملة لواء العروبة، والدول الإسلامية، حاملة لواء الإسلام أبوابها وحرّمت عليهم الاقتراب من هوائها.
عدا دول الجوار السوري التي وجدت نفسها أمام الأمر الواقع، هل يذكر احدكم عدد اللاجئين الذين استقبلتهم الدول العربية بإرادتها مجتمعة؟ إنها لم تستقبل عدد من أسكنتهم ألمانيا في عمارتين.
هل نضيف إليها الدول المسلمة أو الإسلامية لعل الرقم يكبر قليلا؟
هل تساءل أحدكم لماذا يتجه اللاجئون شمالا نحو أوروبا وكندا وأمريكا وليس إلى الدول العربية والمسلمة؟
دول الجوار السوري استقبلت اللاجئين مكرهة ومرغمة، أو لحسابات سياسية معينة تخص الداخل والإقليم. لو خُيّرت تركيا والأردن ولبنان، يستحيل أن تقبل مجتمعة بألف لاجئ بإرادتها، وتستقبلهم مبتهجة.
إذًا، هل هذا هو ثمن الأبواب التي شرّعتها ألمانيا للناس في السنتين الماضيتين؟
وهل هذه مكافأة المجتمع السويدي على تسامحه ونضجه وترحيبه بالآخر، حتى وإن كان هذا الآخر متخلفا وغريبا في كل شيء لا يشبه السويد في شيء؟
وهل هذا جزاء المليارات العشرة التي أنفقها الاتحاد الأوروبي على السوريين المضطَهَدين منذ 2011؟
الحديث عن اللجوء هنا ليس لأنه الوحيد، بل لأنه المثال الأكثر وضوحا على سلامتهم ومرضنا، وإنسانيتهم وتوحشنا.
٭ كاتب صحافي جزائري
الجناة، إرهابيون قتلة غُسلت أدمغتهم بإغراءات من قصص الخيال المجرم، وبالحجج الواهية التي يحق للمرء أن يتساءل كيف تنطلي على بشر.
الضحايا أهداف سهلة ومستباحة.. مدنيون، أطفال ونساء، عُزّل أبرياء لا ذنب لهم سوى وجودهم في المكان الخطأ وفي التوقيت الخطأ.
 ليس كل المسلمين إرهابيين، لكن كل الإرهابيين في هذه الجرائم مسلمون. وكلهم ارتكبوا جرائمهم النتنة تحت يافطة واحدة لا تخرج عن أوهام نشر الإسلام أو الدفاع عنه.
ليس كل المسلمين إرهابيين، لكن كل الإرهابيين في هذه الجرائم مسلمون. وكلهم ارتكبوا جرائمهم النتنة تحت يافطة واحدة لا تخرج عن أوهام نشر الإسلام أو الدفاع عنه.وهذا كاف لإتمام عناصر اللوحة القاتمة لأتباع هذه الديانة في المجتمعات الغربية «الكافرة» التي ذهبوا إليها بعد أن ضاقت بهم مجتمعاتهم «المؤمنة» الطاهرة!
وقفتُ طويلا أبحث عن سبب واحد قد يبرر جريمة ستوكهولم مساء الجمعة، فتعبت ولم أجد. فكرت في معضلة فلسطين وضياع العراق وجوع الصومال ومعاناة الروهنغيا في ميانمار والإسلام الغريب في كل مكان، وفي غيرها، فلم أجد. لم يتقبل ذهني المنهك أن يأتي وحش ويدوس الناس المسالمين بشاحنته المجنونة هكذا كأنه يدوس ذبابا.
وصلت إلى قناعة أنه بعد هذا ليس من حق أحد أن يلوم المجتمعات الغربية إذا ما اتخذت مواقف سلبية أو حتى عدائية من المسلمين. بل لا غرابة ولا لوم على زحف اليمين المتطرف وتنامي مشاعر وجرائم الكراهية.
وانتابتني مخاوف، في المقابل، من أنه سيكون من الصعب جداً بعد اليوم أن تكون فتاةً محجبة في مترو أنفاق لندن أو قطارات ستوكهولم، أو باصات برلين وروما. ستتعب في عيشك مسلما في مدينة أوروبية، مهما كانت براءتك من هذه الجرائم وإيمانك بهذه المدينة وانتماؤك لها، لأن الخسائر فادحة وبلغت حداً يصعب تداركه أو إصلاحه.
سيكون من الصعب، وربما من المستحيل، أن تنجح في الدفاع عن دينك وثقافتك ولغتك في مجتمعات، هناك من بني دينك وثقافتك من يعمل على إبادتها وحرقها.
لو وقف سفاح ستوكهولم في الشارع ذاته في المساء ذاته، واستجدى الناس يعطونه رغيفا، كان سينهي يومه بمائة رغيف وألبسة وأغطية ومصروف يشتري به سجائر، من ذات الناس الذين قتلهم وجرحهم وأدخل الحزن إلى عائلاتهم.
إذا كان هدف الجاني ضرب «الكفر» و»الكفار»، و»العنصرية» والعنصريين»، فهو حتما ضلّ الطريق وأخطأ الهدف. هؤلاء الذين يسقطون بفعل الشاحنات ليسوا كذلك. «الكفر» نحن، و»الكفار» نحن. و»العنصرية» نحن، و»العنصريون» نحن.
نحن الذين نشأنا على رفض الآخر و»الكفر» به ونوغل في ذلك. نحن الذين ترعرعنا في مجتمعات منحرفة علمتنا أننا الأفضل والأنقى والأعلى، وغيرنا الأنجس والأصغر لأنه يختلف عنا عرقا أو دينا، أو الاثنين معا. نحن الذين أقفلنا أبواب بلدان حقيرة وفاشلة في وجوه اليائسين والمستجيرين والهاربين من جحيم حروب سببها جهلنا وظلام عقولنا وتحجر فكرنا. نحن الذين نحلم برؤية المساجد وسماع نداءات الصلوات الخمس في عرين الغرب، ونرفض للآخر مجرد التفكير في بناء كنيسة صغيرة في بلداننا.
غير القيَم الإنسانية والشعور بآلام الآخر، لا شيء يجبر ألمانيا أو السويد أو كندا على استقبال آلاف وربما ملايين اللاجئين الذين من شأن تكاثرهم ان يخلَّ بالتركيبة الديمغرافية للمجتمع. ورغم تلك المخاوف، فقد فعلت بصدر رحب وقلب كبير. آوت الناس وأطعمتهم، بينما أغلقت الدول العربية، حاملة لواء العروبة، والدول الإسلامية، حاملة لواء الإسلام أبوابها وحرّمت عليهم الاقتراب من هوائها.
عدا دول الجوار السوري التي وجدت نفسها أمام الأمر الواقع، هل يذكر احدكم عدد اللاجئين الذين استقبلتهم الدول العربية بإرادتها مجتمعة؟ إنها لم تستقبل عدد من أسكنتهم ألمانيا في عمارتين.
هل نضيف إليها الدول المسلمة أو الإسلامية لعل الرقم يكبر قليلا؟
هل تساءل أحدكم لماذا يتجه اللاجئون شمالا نحو أوروبا وكندا وأمريكا وليس إلى الدول العربية والمسلمة؟
دول الجوار السوري استقبلت اللاجئين مكرهة ومرغمة، أو لحسابات سياسية معينة تخص الداخل والإقليم. لو خُيّرت تركيا والأردن ولبنان، يستحيل أن تقبل مجتمعة بألف لاجئ بإرادتها، وتستقبلهم مبتهجة.
إذًا، هل هذا هو ثمن الأبواب التي شرّعتها ألمانيا للناس في السنتين الماضيتين؟
وهل هذه مكافأة المجتمع السويدي على تسامحه ونضجه وترحيبه بالآخر، حتى وإن كان هذا الآخر متخلفا وغريبا في كل شيء لا يشبه السويد في شيء؟
وهل هذا جزاء المليارات العشرة التي أنفقها الاتحاد الأوروبي على السوريين المضطَهَدين منذ 2011؟
الحديث عن اللجوء هنا ليس لأنه الوحيد، بل لأنه المثال الأكثر وضوحا على سلامتهم ومرضنا، وإنسانيتهم وتوحشنا.
٭ كاتب صحافي جزائري