نعم لتحرير العقل والجامعة! لا للفتنة بين الاساتذة والطلبة والتنظيمات! ج1
بقلم فضيل بوماله
حوادث العنف المتكررة داخل الجامعة ومنها مأساة اغتيال الأستاذ قروي سرحان منذ أيام ماهي الا تمظهرات لسرطنة قديمة انتشرت بصفة شبه كلية في جسدي النظام والشعب وهاهي تلتهم خلاياهما الواحدة تلو الأخرى.
ولذلك، أطرح تصورا جذريا لتغيير راديكالي قبل أن ينهار كلية ويموت ما تبقى من « كياننا الجمعي » مقابل الارتجال بالعلاج المؤقت والشعبوي الذي تقدمه السلطة وعصبها ومقابل وهم الإصلاح من داخل السلطة أو معها الذي ينادي به الطماعون والمرتزقة والخوافون من التغيير الشامل الجذري.
بعد مقتل الاستاذ قروي، ارتفعت أصوات كثيرة هنا وهناك لتكشف بالحق أو بالباطل الفضائح اللامتناهية التي تعيشها الجامعة من الداخل.
وانطلاقا من حراكي ومتابعتي مع زملاء ومجموعات من الباحثين والمثقفين والاساتذة، تجلت لي أمور أربعة:
1. محاولة أطراف معينة خلف الوزارة الوصية تمييع الجريمة وما يحدث من مظاهر العنف يومي في الجامعة ومحاولة تصنيفها في خانة اللاأخلاق ومن ثم نفي كل بعد سياسي وتسييري عنها.
2. محاولة أطراف أخرى اختزال المأساة في مسائل تقنية ومطالب قطاعية وهو ما يفتح المجال لما يشبه التفاوض الظرفي بهدف تحقيق مآرب تختصر في طابعها المادي و »الأمني ».
3. محاولة طرف ثالث استعداء الطلبة عموما والمنظمات الطلابية خصوصا والتركيز عليهما بوصفهما الخصم والمسؤول الاول عن فساد الجامعة والعنف المستشري بها.
4. أما الطرف الرابع فيطرح الأمر كنتيجة لخيارات قديمة ازداد تكريسها بأحجام أكبر في العقدين الأخيرين: دمقرطة وسهولة الالتحاق بالجامعة والخارطة الإدارية التي جعلت من الجامعات تفوق عددا الولايات ولكل ولاية جامعاتها،الخ.
هذه المقاربات ذرية جزئية وتغفل كل واحدة على حدة جوهر المشكلة : لا يمكن لمنظومة تعليمية وجامعية وبحثية أن تكون صالحة وناجعة في بلد يفتقد للرؤية و لأدنى مشروع مجتمع..بلد يحكمه نظام ريعي بوليسي بقواعد العصبوية والجهوية والمحاباة والزبائنية والموالاة واللاكفاءة والجهل وعبادة الشخصية..نظام رأس قيادته لا تؤمن بالعلم والذكاء والكفاءة ونظافة اليد والغيرة الوطنية بل وتعلن الحرب على هذه القيم كلها.
من المفترض أن تكون الجامعة فاعلا ومنتجا للانوار والابتكارات وفضاء للحرية والنقد والإبداع وانتاج النخب..هذا من المفروض وهو حقيقة في مجتمعات ودول أخرى لكن عندنا يتعارض ذلك كلية مع جوهر نظام الحكم وآليات حكمه وغاياته.
وعليه اود التعبير هنا عن قلقي من هذه المقاربات المغلوطة والموجهة وأعبر عن تخوفي من نتائج ذلك على المدى المباشر.
إن اتجاه الطرف الثالث نحو خلق عداوة بين الاساتذة والطلبة والتنظيمات الطلابية (وهو السائد حاليا) لا يشوه النقاش فقط بل يكيل بمكيالين ويمهد لحرب أهلية مصغرة ستنعكس على المجتمع بين عناصر الثلاثي المذكور آنفا.
وهنا أود أن أبدي رأيا مباشرا وصريحا في هذه المكونات الثلاثة واترك لغيري الخوض في مسائل الإدارة في الأقسام والكليات والعمادات ومديريات الجامعات لما تعرفه من فساد وانهيار.
أولا، عن الاساتذة:
جامعاتنا اليوم تضم ثلاثة أجيال من الأساتذة على الأقل إذا ما أغفلنا ما تبقى من وجوه قليلة من أساتذتنا من الجيل الاول لمرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة. جيل التسعينيات ومابعدها هو الأهم من حيث العدد تدريسا وتأطيرا.والنسبة الغالبة من هذا الكم جاءت للتدريس الجامعي بسبب عاملين كبيرين:
1.حاجة قطاع التعليم العالي لاعداد هائلة من الأساتذة تحت ضغط الأعداد الكبيرة الوافدة للجامعة من خلال نتائج البكالوريا المسيسة والشعبوية من جهة وضرورة توفير الكم من الأساتذة لمرافقة ما يسمى بالمراكز الجامعة والجامعات التي صارت تنبت هنا وهناك كالفطريات.ذلك ما انعكس سريعا (من حيث الزمن والنوعية) على مذكرات واطروحات التخرج التي بلغت حدا لا نظير له من الرداءة والانتحال والمحاباة والرشوة والابتزاز والتحرش.
2. تحويل رسالة الاستاذ ومهمة التدريس والمعرفة إلى وظيفة إدارية يقابلها أجر لا غير. وهنا صارت الجامعة ،بحكم ضرورة ضمان استمرارها، مقصدا سهلا لاغلب من لا تتوفر فيهم الشروط العلمية والتعليمية(الديداكتية) والنفسية و الاتصالية وحتى المظهرية والهندامية.
وهذا ما أغرق الجامعة في وحل الكمية الرديئة والترقيات المشبوهة والبداغوجيا الميتة القاتلة.وأخطر من ذلك،وبحكم الأمر الواقع، صارت الجامعة رهينة « لأستذة » زائفة تنفث جهلها،الا من رحم ربك، في عقول طلبة بلغوا في معظمهم الجامعة بحكم أمر واقع آخر أدهى وأمر.
ثانيا،عن الطلبة:
هم إجمالا ضحايا أمور أربعة :
1.ضحايا الفكرة الكارثية التي تقول: « البكالوريا تعني الجامعة ». وذلك في غياب رؤية وطنية لبكالوريا مهنية ترفع من قيمة المهن القديمة والصناعية وتلك التي تولدها يوميا التكنولوجيات الجديدة ومجتمع المعرفة.فالمستقبل للمهن لا للشهادات.
2.ضحايا التوجيه نحو تخصصات جامعية مرتجلة غير مبنية على رؤية مجتمعية واقتصادية ولا تتوافق وقدراتهم الذهنية واللغوية أو حتى طموحاتهم. ما يفوق 80٪ من المتخرجين يعيشون إما البطالة أو يشتغلون مؤقتا في وظائف أو نشاطات لا علاقة لها بدراساتهم وشهاداتهم.
3.ضحايا صدمات نفسية وأخلاقية وهم يكتشفون اوهام واقع تنافي أحلامهم ورمزية حرم تسقط حتى أمام محيطهم الثانوي السابق.
4.ضحايا شهادات التدرج وما بعده وضرورة الحصول عليها بأي شكل كان. وهنا يفتح الباب على الغش والمحاباة والرشوة والعنف والجهوية والتحزب والاغواء/التحرش الجنسي بهدف الحصول على النقاط أو ضرورة ما يعرف ب » نجيب العام وممبعد نشوف ».
ثالثا، التنظيمات الطلابية:
الحركة النقابية الطلابية مهمة للغاية وأدوارها أساسية بيداغوجيا وتنظيميا فما بالكم بمسائل الحراك والوعي. غير أن تلك التنظيمات في حالتنا الجزائرية لم تعد تعكس تلك الرسالة وصارت بؤرة للفساد كالادارة تماما و »ميليشيا » تستغل في غير المقاومة والهدف الصحيحين لكنها برأيي ضحية أيضا لعوامل خمسة:
1. تأسيسها المباشر أو اختراقها عن طريق قياداتها من قبل استعلامات الشرطة والبوليس السياسي(المخابرات) وتوظيفها كمراكز رقابة على الحرم الجامعي أساتذة وطلابا وعمالا. وهذا ما يطرح توسع دوائر التأطير الأمني واستباحته لما كان محرما عليه إلى غاية مطلع التسعينيات.
2. تأسيسها أو ولاؤها المباشر لحزب جبهة التحرير الوطني(وهو الفيروس الأكبر ) ومعه بدرجات أقل حركة مجتمع السلم والارندي وبعض السلفي وكذا الارسيدي وبقايا الحركة الثقافية البربرية وحتى الحركة الشعبية لابن يونس وبقايا النهضة والاصلاح.،الخ. فالاحزاب تريد لها أذرعا طلابية كقواعد ومنظمات جماهيرية لا غير.
3. التنظيمات صارت ضحية النماذج السابقة عليها تأطيرا وقيادات. فكل القيادات الطلابية القديمة على مدى الثلاثين سنة الماضية، بكل اتجاهاتها وولاءاتها، غرقت في الفساد واغتنت بشكل سريع وكبير وعرفت ترقيات سياسية واجتماعية مقابل أدوارها المشبوهة والمتواطئة على حساب الفضاء الجامعي.
4. حتى تعزز من شرعيتها داخل الجامعة، انحازت تلك التنظيمات لمطالب الطلبة الهشة و المشبوهة على حساب المطالب البداغوجية والحقوقية الأساسية والنوعية. ولذلك صارت تتدخل في وضع الأسئلة ورزنامة الامتحانات والاستدراك ومنح العلامات والمعدلات والنجاح والشهادات.وقد بلغت التنظيمات ذلك المبلغ لثلاثة عوامل:
– اطلاعها على فساد الإدارة ومقايضتها الفساد بالفساد.
– معرفتها بزيف مناقشة الأطروحات وكيفيات توظيف الأساتذة وداءة مستوى الأغلبية فيهم ومزالق البعض أخلاقيا ووظيفيا مما جعلها،أي التنظيمات، تساوم الاساتذة الا من رحم ربك مما تبقى من الكفاءات والأساتذة النزهاء. تبدأ بالتدخلات الداخلية والخارجية فالمساومات فالاشاعات ثم التهديد والاضراب فالعنف.
5. إدراكها أن استراتيجية النظام تمر عبر شراء السلم الاجتماعي بأي ثمن حتى يظهر بأنه حقق الاستقرار من جهة وأن الشرائح الواسعة تسانده فيما يسمى مشروعه(قطاع التعليم بأطواره المختلفة يمثل (4/1) ربع السكان تقريبا المقدر ب40 مليون نسمة ويزيد). وعليه، تستثمر في ميزان قوتها بتواطؤ الإدارة الجامعية معها من أجل تحقيق مآربها بأقل تكلفة.
استنتاجات:
1. العنف الرمزي والاكاديمي والجسدي داخل الجامعة ناتج في تقديري عن عوامل أساسية منها:
– التأطير الرسمي الأمني والحزبي والجماعاتي للجامعة وتدخله بالاختراق والتوجيه والتعيين في منظومة الشركاء الأصليين داخل الجامعة.
– تحويل الجامعة إلى جهاز كجهاز الأمن و الاحزاب- الدولة الفاسدة والمعسكرة.
– خنق كل إمكانية لاستقلالية الجامعة وتحولها رمزيا وأكاديميا الى مصدر للحرية والنقد والمشاريع البديلة المناهضة لتوجهات النظام وسياسات السلطة العامة.
– تمييع رسالة الجامعه والحاقها بخيارات السلطة وتوجهاتها.
– استنساخ الرداءة والفساد في الجامعة قياسا على المنظومات الاخرى.
– الجامعة ومن ثم إنتاج النخب والمعارف ليست من أولويات النظام فما بالكم بأدوارها في عمليتي صناعة واتخاذ القرار.
– لا يمكن معالجة أمراض النظام والتربوي عموما والجامعي البحثي خصوصا دون مشروع مجتمع حقيقي محددة قواعده وأهدافه وآليات عمله.
– التجريم يجب أن يكون للنظام ومخططاته وليس لاعراضه ونتائجه على المستوى الجمعي.
– الحذر ثم الحذر من السقوط في شرك التصنيفية والتمييز ومن ثم تحميل المسؤوليات لهذا الطرف دون ذاك(أساتذة،طلبة،تنظيمات طلابية،الخ). فبإمكان ذلك أن يوجه النقاش ويشوهه ويختزله في قطاع واحد بل ويمكن أن يؤدي إلى مواجهات فرعية بين الاساتذة والطلبة وبين التنظيمات الطلابية و الاساتذة و يفجر بينها ما يشبه حرب أهلية مصغرة ستكبر كحبة الثلج.
– الجسد الجامعي بكل شركائه مسرطن كباقي المجتمع. وكل علاج بالبتر أو بالكيمياوي يجب أن يمس الخلايا المسرطنة كلها بهدف التخلص من السبب الرئيس في ذلك برمته: طبيعة نظام الحكم وممارسات السلطة و الحالة الذهنية والنفسية التي آل إليها المجتمع.
– تحرير العقل ومن ثم الجامعة من السلط القهرية السياسية والدينية والمالية المحكمة قبضتها عليهما خطوة أولى لتحرير الإنسان وتمكين المجتمع والدولة من الميلاد.
هكذا يبدأ التفكير في تغيير جذري شامل حول أي إنسان جزائري جديد نريد؟ أي نظام سياسي جديد نريد؟ أي حكامة جديدة نريد؟ وأي مجتمع جزائري جديد نريد؟
ماعدا هذا، أي جهد ،ولو كان صادقا، سيطيل في عمر النظام ومخاطره على الأمن القومي وسيزرع المرة الواحدة الأخرى فتيل الفتن الأهلية القادمة.
فضيل بوماله




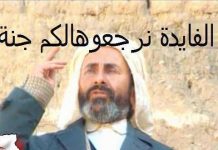










Le tournant intervient au début du XVIe siècle, en 1502, précisément, quand Ismaïl prend le pouvoir en Perse, fonde la dynastie des Safavides et proclame le chiisme religion d’Etat. Un choix très politique. Un empire se crée, face à un autre, celui des Ottomans. Le premier est duodécimain, le second sunnite.
Les Safavides ont adopté le chiisme certainement pour se démarquer des Ottomans. »
Très vite, leurs armées se combattent. Mais ces guerres opposent davantage des souverains que des peuples ou des croyances. Et, durant les siècles suivants, la frontière entre les deux empires « est l’une des plus stables du monde musulman », rappelle l’historien Jean-Pierre Filiu. Elle correspond à peu près à celle qui sépare actuellement l’Iran de l’Irak.