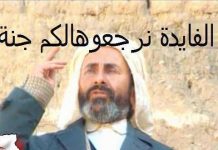https://alsiasi.com/
بشير عمري

يظن البعض أن طبيعة الأزمة الراهنة والمحصورة أساسا في ذاك الصراع المحتدم الحاصل داخل السريا وغرف القرار المظلمة، لا تستدعي في سياق تفسيرها الايغال الكلي في دقيق تريكيبة النظام الجزائري وتفتيش جيناته وطرائق تفكيره، وهذا عين الخطأ في أي مسعى يُرام منه تناول مسألة الحكم بالجزائر باعتبارها العقدة الصعبة في تاريخ البلد السياسي مذ انتزع بالدم استقلاله بداية ستينيات القرن الفائت، لتدخل الوطنية فيه مرحلة الذم المتبادل والدم السائل بين مختلف التوجهات والتشكيلات المتصارعة على السلطة وشرعيتها.
وما دام الأمر بقيا في المربع الأول للأزمة وهو التدافع والتصارع حول السلطة بعيدا عن إرادة التداعي للمبادئ الديمقراطية المفضية إلى قيام شرعية قانونية دستورية شعبية، فإن أي محاولة لقراءة الواقع تغفل عن هاته العناصر وسياق تعامل السياسي من سلطة ومعارضة ستؤل بصاحبها بالضرورة إلى حمل فهم خطائ لطبيعة الأزمة.
من أهم مواقع سقوط مشروع دمقرطة العمل السياسي في الجزائر، قدرة النظام، ليس فقط على الاندراج في التعددية وهي نقيضته في الشكل والمضمون، بل أكثر من ذلك قدرته على ستيعابها والهيمنة والتحكم فيها سيرا وتدبيرا دون تركها تتطور بالشكل الطبيعي، ووفق إرادة وشاكلة تفاعلها مع المجتمع.
كيف تمكنت السلطة من الاستحواذ على الارادة التعددية والخروج من أسر الأحادية التي كبلت القدرات الوطنية منذ الاستقلال؟ وهل صار أفق السياسي الآن هو تحرير نفسه من النظام بعدما كان هدفه تحرير المجتمع منه؟.
واضح أن المعارض الجزائري الذي ظهر إلى العلن بعد أكتوبر 1988 لم يكن على قدر كاف من الدراية بطوايا النظام ونيته في عدم التخلي عن السلطة التي حسبها ولا يزال خاصته من بين كل موروثات الاستعمار، وأنه كان ولا يزال ممكنا منازعته في أي شيء من رموز وحقائق تاريخية وأبعاد مجتمعية يموج بها النقاش النخبي الفارغ الذي ملأ ابراج المثقفين المتأدلجين العالية، إلا السلطة التي دونها سيكون الدم وقد كان فعلا لمدة عشرية كاملة من السواد.
ولعل سائل يسأل فلمَ انتقل من الأحادية التي كانت تضمن له الميكانيزم الأمثل لابقاء سيطرته الدائمة على السلطة بمختلف مستوياتها؟ والاجابة هنا واضحة متعلقة أولا بحالة التطور الحاصلة داتخل بنية هذا النظام نتيجة التناقضات التي صار يعيشها تسببت له فيها متغيرات تاريخية بعضها موضوعية وبعضها ذاتية، وكذا بإرادته الاتصال الشكلي بالنموذج العالمي بالسياسة الذي نبذ نظم الأحادية، لكن مع حرص “عقل النظام السياسي المدبر” في الجزائر على أن تظل التعددية في قبضته وفق الأجندة التي سطره بحيث تلعب ذات الدور الذي كانت تلعبه الأحادية.
التعددية في الجزائر افتتحت على ثلاث عائلات كبرى، إسلامية، وطنية وعلمانية، وجودها بهذه الصغة، فرض أليا على الوعي الجديد طرح سؤال عن طبيعة المشروع الذي قاد به النظام المجتمع في ظل عقود ثلاث من تغييب الشعب عن سوق السياسة وبضاعته المتنوعة التي تطرحها أو المفروض أن تطرحها تلك التيارات الرئيسة.
وطبعا واضح أن النظام لم يكن مهتما بمشروع مجتمع قدر اهتمامه بالدولة وسلطتها وكيفية الحفاظ عليهما من خلال التغلغل الجماهيري الذي تتيحه له المنظمات التي حملت صفة الجماهيرية وكذا الهيئات والجمعيات الشبانية والنقابات الحرفية والعمالية، في حين كان مشروع الأحزاب والتيارات داخل تلك العائلات الكبرى الثلاث، هو تحرير المجتمع من هذا النظام لكن من خلال مسار ضيق هو الحلول محل هذا النظام، وهنا تحديدا يكمن التفصيل والفيصل الجوهري في ارتكاس قوى المعارضة الجادة وعدم نجاحها في فرض التعددية الحقيقية أولا المفضية فيما بعد إلى تحقيق التغيير، بل أكثر من ذلك سلمت رقبتها للنظام كي يقتادها إلى حيث خطط وسطر في أجندة استدامته في الحكم، لأن بين التحرير والحلول فارق إجرائي كبير بل ومصير، ذلك لكون الخيار الاستراتيجي للتحرير فيما لو اتبع كان سيفرض وحدة براغماتية آلية تعطي قوة دفع شعبية تمكنها من تجاوز كل الوسائل الضخمة التي يحوزها النظام وبها يواجه تهديدات اقتلاعه، على شاكلة ما حصل في بولونيا مع نقابة التضامن المحضورة التي وحدت كل قوى التغيير ضد الحزب الشيوعي الحاكم سنوات الثمانيينات، أما الحلول محل النظام الذي مضت عليه تجربة التعددية الأولى في الجزائر المستقلة، فاستوحته تياراته لا سيما الاسلامية منها من كثرتها متصورة أنها وحدها الأقدر على اسقاط النظام وبالتالي تغدو وحدها الأحق بحكم المجتمع أي أن ترث النظام في كل ما سيترك.
ولما دنت قوى المعارضة الجادة من إدراك فداحة الخطأ وفظاعة الخطيئة، وأرادت تدارك الأمر، كنت الوقت قد فات، إذ استبقها النظام حينها وتحديدا عشية 11/01/1992 إلى بسط كل قواه وإرادته على المسرح السياسي، متحكما في أدوات إنتاج السياسة، بمختلف عناصرها، البشرية، المشاريعية، وبالتالي إعادة إنتاج المشروعية التي يريدها هو .
أنتج الاسلامي الذي ينتهي أفق وجوده في الساحة عند المشاركة في مؤسسات الدولة وفق الحصة المقدرة لهذا التيار، ما أحدث تزاحما في الطموح داخل هذا التيار ذو الوعاء الشعبي الانتخابي الكبير، تزاعم تسبب في انشقاق للوعاء وتسرب وتسيب لقادته كما لقواعده، وعندما ترى خطابات البعض من هؤلاء القادة وميقات سكوتهم وتكلمهم، كميقات خروج بن قرينة القوي إلى العلن مع اندلاع الحراك وتصدره للمنبر الاسلاموي تدرك بأن السلطة فعلا قد تمكنت من صك اسلامييها وفق قالب تعدديتها النموذجي.
ذات القول انسحب على التيار الوطني الجاد والجدي، الذي كان مضطهدا مستعملا داخل مشروع النظام في الاستحواذ على السلطة، حيث ضرب رأس هذا التيار ممثلا في عقله وروحه الراحل عبد الحميد مهري، وأعادت إلى الواجهة جماعة الطاعة وتمثيل دور سلطة الواجهة .
أما العلمانيين فقد تمكن النظام عبر أدواته من استقطاب العديد من عناصر نخبها التي ظلت لعقود شرسة في نقد لا مشروعه الساسي والاجتماعي داخل أقبية المعارضة السارية وبعدها في المنابر الخطابية في فترة الافتاح الأولى، قبل أن تسقط في طاحونة مغريات السلطة وشهواتها، وتنقلب إلى مبرر لبقاء النظام بحجج ,احاجي يجيد عقل هذا التيار صياغتها.
في ظل هذا المآل الجدلي الثنائي بين السياسي المعارض في الجزائر والنظام أين وجد هذا المعارض نفسه داخل شراك النظام يحاول أن يتحرر من القبضة التي هو اقع بها، حتى نسي مشروعه الأول ومبرر نضاله ووجود التاريخي أي تحرير المجتمع ودمقرطته – في ظل ذلك – برز الشعب بوعيه المستقل عن هذه الثنائية الجدلية، حين رفع شعاره الشهير “يتنحاو قاع” بمعنى الكفران الصريح بالنظام والمعارضة وإحالة ملفيهما على أرشيف الذاكرة، وهذا الاستفراغ الشعبي للرواسب السياسية القديمة هو ما يشكل أزمة الفراغ السياسي الكبرى الحالية التي يعرفها جهاز الحكم والسياسة بالجزائر.
كاتب صحفي جزائري